طبيعة الصورة السينمائية والتليفزيونية
برغم الاعتقاد السائد بأن الكاميرا السينمائية تسجل صورة مطابقة للواقع إلا أن هذا التطابق هو فى حقيقته تطابق ظاهري ولا يمثل صورة طبق الأصل تمامًا . فمن الناحية المبدئية ، هناك فوارق رئيسية بين رؤية الكاميرا للواقع , ورؤية الإنسان له
.. وهذه الفوارق كما يقول "رودلف ارنهايم " فى كتابه " فن السينما " تمثل
فى مجملها قصورًا فى رؤية الكاميرا بالمقارنة بالرؤية الإنسانية ، ولكنه
بمثابة القصور الإيجابي الذى جعل من الفيلم فنًا . ومعرفة السينمائي
للعناصر التي تكون هذا القصور تمثل أساسا هامًا فى توظيفه الخلاق للصورة السينمائية
. وفن الفيلم كما يقول " مارسيل مارتن " فى كتابه "اللغة السينمائية" لا
يقدم صورة طبق الأصل من الواقع بل يقدم ما يمكن تسميته " الواقعية الفنية "
. وعلى ذلك فإن تقدير قيمة التأثيرات الجمالية للصورة السينمائية يتطلب من الناحية المبدئية التعرف على أهم الفوارق بين رؤية الكاميرا والرؤية الإنسانية , ودراسة أبعادها من منظور جمالي يتجاوز مجرد تسجيل الكاميرا للواقع الموجود فى مجال رؤيتها .أولاً : تسطيح الصورة السينمائية :
يتمثل أول الفوارق بين رؤية الكاميرا والرؤية الإنسانية فى أبعاد الانطباع البصري لكل من الرؤيتين :
أولاً - الإدراك الإنساني لصورة الواقع يتمثل فى صورة ذات أبعاد ثلاثة ، وهذه الأبعاد هي الطول(أو الارتفاع) , والعرض , والعمق ، فبينما تمثل ثنائية الارتفاع والعرض بعدى إطار الرؤية ، فإن الإدراك البصري الذى يمتد فى عمق الصورة يمثل البعد الثالث.ثانياً - رؤية الكاميرا لصورة الواقع تنتج فى النهاية صورة تعرض على مسطح ذي بعدين : الارتفاع والعرض ، أما البعد الثالث فهو وإن كان من الناحية المادية بعدًا مفقودًا بسبب تسطح شاشة العرض , إلا أننا نتوهم وجوده نتيجة تفاعل إدراكنا العقلي لعناصر الصورة المتماثلة مع الواقع ومع إدراكنا البصري للعناصر التشكيلية التي تلعب دورًا رئيسيًا فى تقوية هذا الإيهام ويتمثل أهمها فى :
1. الأجسام والكتل المتواجدة على أبعاد متوالية فى عمق الرؤيةمن أمامية الصورة إلى خلفيتها , مثلما فى حالة تواجد عدد من الأشخاص فى غرفة مثلاً تتفاوت أوضاعهم ما بين أقرب موضع من الكاميرا الى أبعد وضع فى نهاية الغرفة , ونظرًا لطبيعة قصور رؤية الكاميرا فسوف تبدو أحجام الأشخاص متدرجة من الأكبر (فى مقدمة الصورة) إلى الأصغر فى خليفتها , مما يقوى من الإيهام بالعمق (البعد الثالث ) .2. الخطوط المتوازية وتمتد من ناحية الكاميرا إلى اتجاه عمق الرؤية ، مثل الخطين المحددين لمنضدة تبدو مقدمتها قريبة من الكاميرا وتمتد فى اتجاه العمق , كما تمتد خطوط التقاء حائطي غرفة مع السقف أو الأرضية (أو هما معا ) فى اتجاه العمق, وكذلك الحال بالنسبة للخطوط المتمثلة فى قضبان مسارات القطارات ، فنتيجة للقصور فى رؤية الكاميرا بالمقارنة بالرؤية الإنسانية , تبدو مثل هذه الخطوط و كأنما تميل إلى التلاقي وهي متجهة إلى العمق . وهذا الميل الظاهري الذى نستشعره على مستوى الواقع فى مسافات العمق البعيد جدًا مثل النظر إلى مسار قضبان قطار ، يحدث أثره فى المسافات القصيرة من خلال الصورة السينمائية .3. التدريجات الضوئية و تبايناتها ما بين مقدمة الصورة وخلفيتها ، فنظرًا لحقيقة قصور رؤية الكاميرا وعرض الصورة على مسطح , تبدو هذه التدريجات والتباينات أقوى تأثيرًا فى الصورة السينمائية وتلعب دورها الهام فى تقوية الإيهام بالعمق .4. الحركة من وإلى الكاميرا , كحركة الأشخاص والأشياء المتحركة , وكذلك حركة الكاميرا فى اتجاه العمق أو منه ، فمثل هذه الحركات تؤدى دورها أيضًا فى تقوية الإيهام بالعمق ..إن أى من هذه العناصر أو بعضها أو كلها يسهم إسهاما فعالاً فى خلق هذا الإيهام بالعمق ، ولتأكيد هذه الحقيقة فإنه يمكننا التحقق من ذلك لو تخيلنا وضعًا للكاميرا عند أول حدود غرفة ما مثلاً ووجهناها إلى ناحية الحائط البعيد دون أن يظهر أى جزء من أرضية الغرفة أو سقفها أو أى جسم فى الفراغ الواقع بين الكاميرا والحائط .... فعندما تصور الكاميرا هذا الحائط ثم نقوم بعرض النتيجة على سطح الشاشة , فإن الحائط البعيد على مستوى الواقع ( فى البعد الثالث ) سيبدو فى الصورة المسجلة له وكأنه فى أمامية الصورة تمامًا وكمجرد سطح يشغل كل مساحتها ..... وعلى ذلك فإنه لو قمنا بتعديل التجربة ووضعنا جسمًا قريبًا من الكاميرا أو على مسافة متوسطة ما بين الكاميرا والحائط لبدت الصورة الجديدة وقد اكتسبت أولى درجات الإيهام بوجود البعد الثالث .وتأسيسًا على كل ما تقدم فإن أولى المبادئ الهامة فى التعامل مع الصورة السينمائية يتمثل فى أن نتعلم كيفية النظر إليها من خلال منظورين فى وقت واحد، هما :1- حقيقة أنها مسطحة .2- حقيقة الإيهام باحتوائها على بعد ثالث . ولهذا يقال بأن الصورة السينمائية ليست ذات بُعديين بشكل مطلق ، وليست ذات ثلاث أبعاد تمامًا ، و لكنها تجمع بين هذين النقيضين ، وبصرف النظر عن رؤيتنا للصورة من منظور واقعي من حيث تعرفنا على مضمون ما يظهر فيها ، فإن تسطيح الصورة هو الذى يكسبها تأثيرها الجمالي .ولهذا فإنه ينبغي أن نتدرب على كيفية إدراكها من منظور تشكيلي أو تجريدي إلى جانب إدراكها على أنها تمثل الواقع , فرؤية سيارة مثلاً وهي تجرى داخل إطار الصورة هي أيضًا رؤية لمساحة محدودة ذات شكل معين ودرجة ضوئية أو لونية معينة . وبالمثل فإن رؤية شخص ما يرتدى سترة بيضاء يحتل الثلث الأيمن أو الأيسر من الصورة , هى فى نفس الوقت رؤية لمساحة بيضاء ذات ضوء مبهر تشغل هذا الحيز , ولو كان هناك بخلفية هذه الصورة الأخيرة باب مفتوح على غرفة ذات ضوء ساطع , فإن الضوء الصادر من الباب سيخلق علاقة تشكيلية مع السترة البيضاء فى مقدمة الصورة فبقدر رؤيتنا للباب فى الخلفية كباب فى العمق (بعد ثالث) , فإننا نراه أيضًا كمساحة ضوئية على نفس السطح (تسطح الصورة) الذى تظهر عليه السترة البيضاء .... و بنفس المفهوم فيما يتعلق بالعناصر المتحركة ، فإنه يمكننا أن نرى شخصًا يتحرك متقدمًا من الخلفية نحو الكاميرا ( صورة ذات بعد ثالث) على انه مساحة ذات درجة ضوئية أو لونية معينة تكبر وتنتشر تدريجيًا نحو أطراف الصورة (صورة مسطحة) - والعكس صحيح , فالحركة المبتعدة من الكاميرا تبدو فى نفس الوقت وهى تتضاءل وتنكمش تدريجيًا من اتجاه أطراف الصورة نحو نقطة مركزية على سطح الصورة . ولو غيرنا من وضع الكاميرا بالنسبة لهذه الحركة القادمة من العمق أو المتجهة إليه ، فوضعناها فى رؤية مرتفعه تماثل رؤية "عين الطائر" فسوف تبدو حركة الشخص على سطح الصورة مختلفة تمامًا ، حيث نراها تتجه من أعلى الصورة إلى أسفلها (بدلاً من تحركها من العمق) أو من أسفل الصورة إلى أعلاها (بدلاً من تحركها إلى العمق) و يترتب على ذلك تضاؤل الإيهام بالبعد الثالث إلى حد كبير .ثانياً : وضع الكاميرا بالنسبة لموضوع التصوير :
فى الحياة الواقعية نتواجد فى الأماكن المختلفة تبعًا لرغباتنا وتلبية لحاجاتنا الإنسانية . وعندما نستقر فى حيز معين بمكان ما، فإننا ننظر إلى الأشخاص الآخرين أو الأشياء المحيطة بنا من هذا الوضع الثابت حتى نغيره لضرورة أو رغبة إنسانية غالبة لنستقر فى وضع ثابت جديد لزمن ما إلى أن يتم مرة أخرى , وهكذا . وفى أى من هذه الأوضاع يكفينا أن نرى ما نرغب فى رؤيته أو يتصادف وجوده فى مجال رؤيتنا , وأن نراه بوضوح كاف . ومن ثم فإن الرؤية الإنسانية للواقع المحيط فى ظروف الحياة اليومية تبدو كإدراك بصري تلقائي نمارسه بشكل آلى دون التفكير فيه ما دمنا نتعرف على الأشياء بوضوح كاف .
أما فى الرؤية السينمائية ، فإن هذا الاعتياد التلقائي ينتقل برمته إلى سلطان مخرج الفيلم الذى يتحكم فى تحديد الوضع الذى ننظر منه كمتفرجين إلى أى شئ , وفى تحديده لوضع الكاميرا بالنسبة إلى موضوع التصوير, فمن المفترض أن يحدد هذا الوضع بما يتيح للمتفرج التعرف على ماهية الشئ المصور و كينونته ، إلا أن هذا لا يعنى أن يضع الكاميرا فى أى موضع يمكن منه رؤية هذا الشئ . ذلك لأن حقيقة تسطح الصورة قد تظهر الشئ بغير حقيقته أو بغير مواصفاته إن لم يتم اختيار موضع الكاميرا بعناية .ولإثبات ذلك , يسوق رودلف ارنهايم مثالا تطبيقيا فيقول : لو كنا بصدد تصوير مكعب مثلا , فإن وضع الكاميرا في مواجهة سطح أحد جوانبه سوف يبدو كسطح مربع ويخفي لنا انه أحد أسطح المكعب . وإذا قمنا بتحريك الكاميرا قليلا إلي اليمين أو إلي اليسار فسوف نري سطحين متعامدين , وبرغم إكسابهما الصورة شئ من العمق إلا أنهما لا يقطعان بحقيقة أنهما ينتميان إلي مكعب . أما إذا قمنا من هذا الوضع الأخير برفع الكاميرا قليلا حتى تظهر لنا السطح العلوي للمكعب بالإضافة إلي سطحي الجانبين , فسوف نري ثلاثة أسطح تمثل القدر اللازم للقطع بحقيقة أننا نري مكعبا .وبرغم أن هذا المثال يؤكد مبدأ اختيار وضع الكاميرا للتعرف علي حقيقة الشيء أو مضمونه , إلا أن هذا لا يعني مجرد توصيل المضمون المباشر له , بل يمتد إلي ما يرتبط به من صفة أو صفات . فلو كنا بصدد تصوير جندي في ميدان القتال , فلا يكفي أن نضع الكاميرا في أي موضع يتيح لنا رؤية الجندى والتعرف عليه , بل ينبغي اختيار الوضع الذي يظهره بصفات التحفز والقوة ... وهذا يقودنا إلي تخفيض مستوي الكاميرا حتى نري الجندي من أسفل إلي أعلي بما يكسب تكوينه الجسماني ديناميكية تضفي عليه صفات تتجاوز مجرد مظهره كجندي . وبالمثل لو أننا بصدد تصوير شيء بسيط كباقة من الزهور مثلا , فلا يكفي أن نصورها بما يظهر حقيقتها المادية المباشرة , بل سنسعى نحو اختيار الوضع الذى يضفى عليها صفات الجمال, والذي قد يكون أعلى من مستوى النظر قليلاً . وفى هذا الخصوص أفصح أحد مخرجي السينما الأمريكية " ادوارد ديميترى " أنه اعتاد أن يصور اللقطة القريبة لوجه الشخصية من أسفل قليلاً , حيث أن هذا الوضع يظهر تعبير العينين بتأثير أقوى من حالة التصوير من مستوى النظر ...
بالإضافة إلى كل ذلك , فإن المخرج يضع فى اعتباره أنه يتعامل مع صورة تكتسب صفات تشكيلية تنبع من حقيقة أنها مسطحة , وأنها تعرض داخل إطار محدد. ومن ثم فإن هذا يفرض عليه أن يسعى إلى إشباع مشاعر المتفرج بالتذوق الجمالي لها من خلال ترتيب عناصرها وتحديد علاقاتها ببعضها البعض من ناحية تكوينها التشكيلي العام من ناحية أخرى .وحيث أن المخرج يسعى أولاً وأخيراً إلى عرض فيلمه بأسلوب يؤثر فى وجدان المتفرج ويخلق لديه متعة المتابعة , فإن سبيله إلى ذلك يتمثل فى اختيار أوضاع للكاميرا بين الحين والأخر تمكنه من خلق بعض المؤثرات الفنية مثل التشويق والمفاجأة والرمزية : 1: لو أن المخرج بدأ أحد المشاهد دون التركيز الصريح على موضوعه الرئيسي , واظهر لنا إحدى الشخصيات وهى تنظر إلى خارج الصورة باهتمام شديد فإنه سيخلق لدى المتفرج تشوقاً لرؤية ما تنظر إليه . أو أن يبدأ مشهداً بالتركيز على جانب من غرفة ما بينما نسمع صوتاً غير مميز من خارج الصورة فتتولد لدي المتفرج الرغبة والتشوق فى معرفة ماهية هذا الصوت ومصدره. 2 : فى مجال اختيار وضع الكاميرا الذي يمكنه من إحداث تأثير يحمل مفاجأة , فإنه يستطيع أن يحقق ذلك بتقديم صورة ترسخ فى أذهاننا مضموناً محدداً ثم نفاجأ بعد ذلك بما يخالف هذا المضمون . وفى هذا الخصوص يسوق "رودلف ارنهايم " مثالاً فريداً اختاره من أحد أفلام شارلي شابلن القديمة الصامتة بعنوان " المهاجر ".... والمثال يصور قارباً يحمل مجموعة من الركاب فى جو بحري عاصف ... ويبدو الركاب وهم يعانون من اضطراب القارب فى اهتزازات عنيفة , ومن بين هؤلاء نلمح شارلي شابلن فى خلفية الصورة عند حافة القارب وقد تدلى نصفه العلوي إلى خارجه بينما تتأرجح ساقاه فى الهواء , وكأنه وهو فى هذا الوضع يفرغ ما فى جوفه إلى مياه البحر. ثم تحدث المفاجأة عندما ينتصب شابلن فجأة ويستدير فنراه ممسكاً بسمكة كان منهمكاً باصطيادها....ويؤكد ارنهايم على أن المفاجأة اعتمدت بالدرجة الأولى على ذلك الوضع المختار لوجهة نظر الكاميرا الذى أوهم المتفرج فى البداية أن شابلن كان يعاني مثل الآخرين , إلى أن ينقلب هذا المضمون رأساً على عقب مع مفاجأة الإفصاح عن حقيقة موقفه . ولو أن المخرج وضع الكاميرا فى البداية من الناحية الأخرى لنرى شابلن فى محاولته لاصطياد السمكة بشكل صريح لتبدل الأمر تماماً ولما كانت هناك مثل هذه المفاجأة . وفى فيلم " نفوس معقدة Psycho " يقدم مخرجه ألفريد هيتشكوك توظيفاً بارعاً يجمع فيه ما بين التشويق والمفاجأة , وذلك عندما انتهت الفتاة الهاربة بالمبلغ المالي من استبدال سيارتها بأخرى بعد متابعة رجل الشرطة لها ووقوفه فى جانب من فناء محل بيع السيارات يراقب الموقف بما يوحي باحتمال القبض عليها فى أى لحظة . وفى اللحظة الحاسمة التي تتهيأ فيها الفتاة لركوب السيارة الجديدة , يركز هيتشكوك على الفتاة دون رؤيتنا لرجل الشرطة ... وما أن تتحرك بالسيارة حتى نسمع صيحة عالية من خارج الكادر موجهة للفتاة كى تتوقف .. ومع سماع الصيحة يوحى الموقف بأنه سيتم القبض عليها ... ثم نرى أحد عمال المحل يظهر فى الكادر حاملاً حقيبة ملابس الفتاة التي نسيتها فى السيارة المستبدلة , وينقلب الموقف إلى مفاجأة تخالف توقع المتفرج وتأخذ الفتاة حقيبتها وترحل دون تعرض رجل الشرطة لها. 3: أما عن توظيف وضع الكاميرا ليضفى على الصورة معنى رمزي , فإن رودلف ارنهايم يسوق لنا مثالاً من فيلم للمخرج الروسي "بودفكين" بعنوان "نهاية سانت بيترسبورج " يصور لنا موقف أثنين من الفلاحين البسطاء وهما يدخلان إلى المدينة لأول مرة فى شيء من الخوف والإحساس بالاغتراب . ويصف ارنهايم تكوين الصورة التي تمثلت فى وضع الكاميرا فى مكان عالى خلف تمثال للقيصر وهو راكب على حصانه , بينما يظهر الفلاحان على بعد سحيق وهما يعبران الميدان , فيبدوان مثل نملتين تزحفان بالقياس إلى ضخامة الجزء من التمثال الذى يشغل معظم الكادر فى حجم ضخم . ويستطرد ارنهايم فى تحليله للكادر فيقرر بأن هذه الرمزية التي تم إضفائها على الفلاحين اعتمدت بالدرجة الأولى على هذا الاختيار الذكي لوضع الكاميرا من ناحية , وحقيقة تسطح الصورة بما يستتبع هذا من قصور ينتهى إلى تجسيد هذه المبالغة البصرية فى الأحجام , ما بين مقدمة الكادر وخلفيته . ثالثاً : حدود الصورة ( الإطار) : إن ممارسة رؤيتنا للواقع , تتم فى نطاق مجال بيضاوي يمتد أفقياً على مدى 180 درجة ما بين أقصى اليمين وأقصى اليسار, كما يمتد رأسياً ما بين أسفل وأعلى على مدى حوالي 90 درجة. وعندما نركز البصر على شيء ما , فإننا نشعر بحدة الرؤية فيما نركز عليه , بينما تقل هذه الحدة تدريجياً من نقطة التركيز فى اتجاه اليمين واليسار وإلى أعلى وأسفل , وهذا التدرج ينتهي إلى ما يمكن اعتباره حدوداً على مجال رؤيتنا . ومع ذلك فإننا نشعر دائماً وكأن رؤيتنا لا تحدها مثل هذه الحدود , وينشأ هذا الشعور بسبب التحريك المستمر للنظر من نقطة انتباه إلى أخرى , وكأننا نمارس رؤية بلا حدود على مجالها . أما فى حالة رؤية الكاميرا للواقع فإنها تتم من خلال أربعة حدود تظهر واضحة تماماً للمتفرج وهو يتابع الصورة السينمائية كفواصل حادة تفصل بين ما يقع داخلها وما يقع خارجها مباشرة فصلاً حاداً. هذا فضلاً عن أن ما يقع داخل هذه الحدود يمثل أفقياً نسبة تتراوح بين 35 و 45 درجة بالمقارنة بمجال الرؤية الأفقي على مستوى الواقع الذى يبلغ 180 درجة . فإذا أضفنا إلى ذلك فقدان المتفرج لما يقترن بالإدراك البصري على مستوي الواقع من حرية تغيير مجال الرؤية ذاتياً وفورياً فى أى لحظة, فإنه فى وضع يفرض عليه رؤية صورة من الواقع داخل إطار محكم يخضع لسلطان المخرج أولاً وأخيراً والذي يحدد القدر الذى يقتطعه من الواقع ليضعه داخل إطار الصورة , والتوقيت الذى يظهر فيه ذلك أو يخفيه . من ناحية أخرى فإن المخرج يتعامل مع إطار الصورة كأداة تشكيلية من الدرجة الأولى تفرض متطلبات جمالية فيما يتعلق بأوضاع عناصر الصورة بالنسبة إلى بعضها البعض من ناحية , وبينها وبين إطارها من ناحية أخرى . وعلى ذلك فإن إطار الصورة الذى يفرض على المتفرج معايشة وضع يختلف عن تحكمة فى ممارسة إدراكه البصري على مستوى الواقع - يصبح فى يد المخرج أداة ذات شأن كبير فى تكوين رؤيته الخلاقة . وإذا حاولنا أن نتبين إمكانيات إطار الصورة الجمالية والخلاقة , فإننا سنرى أن الإطار يمثل : 1- آداة تشكيل رئيسية , لموازنة تكوين الصورة .2- آداة إختيار وتحديد , للقدر الذى يظهر داخل الصورة .3- آداة تركيز , تحصر انتباه المتفرج فى عنصر او تفصيلة معينة ذات أهمية خاصة .4- آداة حجب أو عزل , لما قد يشتت انتباه المتفرج بعيداً عن عنصر رئيسي ينبغى التركيز عليه . 5- أداة تأكيد , عند الانتقال من العام إلى الخاص أى (من لقطة عامة Long Shot إلى أخرى قريبة Close UP ) وبالعكس عند الانتقال من الخاص إلى العام أى (من لقطة قريبة Close UP إلى أخرى عامة Long Shot ). وقد يتم هذا الانتقال تدريجياً من خلال حركة الكاميرا نحو عنصر محدد وبالعكس , وفى هذه الحالة يبدو دور الإطار كما لو كان يضيق من الرؤية أو يوسع منها . 6- تكتسب اللقطة القريبة Close UP تأثيراً خاصاً على أكثر من مستوى , مثل تكثيف لحظة درامية أو تفسير ما تفكر فيه الشخصية عندما تكون من وجهة نظرها , أو تكون رمزاً لمكان ما , او شخصية معينة.7- إمكانية توظيفه فى خلق عنصر التشويق فى توقيت معين .8- إمكانية توظيفه فى خلق المفاجأة .ومن بين هذه الإمكانيات تبدو الثلاث الأخيرة منها ذات أهمية خاصة إذا تم استخدامها بوعي :1: ففي مجال توظيف حدود الصورة مع اللقطة القريبة Close UP , وخاصة عندما تكون العين هي العنصر الرئيسي فى التعبير, نرى على سبيل المثال الفريد هيتشكوك فى فيلم نفوس معقدة Psycho يقدم مثل هذا التوظيف الخلاق فى لحظة تلصص الشخصية الرئيسية (نورمان) على الفتاة الهاربة بمبلغ المال عندما تستقر فى غرفتها الملاصقة لغرفة مكتب الفندق , وعندما تبدأ فى إعداد نفسها للاستحمام .. يرفع نورمان إحدى الصور من على الحائط لنفاجأ بوجود ثقب كبير نسبياً يمكنه من خلاله التلصص على ما يدور فى الغرفة المجاورة .. وفى لقطة قريبة جانبية Close UPSide angle لوجه نورمان نشعر من خلاله نظرة عينيه برغبته الشديدة نحو الفتاة .ولهيتشكوك أيضا مثال أخر فى فيلم بعنوان أنى اعترف I confess نرى فيه مفتش الشرطة وهو يسأل احد الأشخاص عن ظروف توقيت تواجده فى الكنيسة (مكان ارتكاب جريمة القتل) .... ويستطرد فى أسئلته بينما ينقل نظرته ما بين الرجل وبين ناحية الشارع , متوقعا ان يظهر المشتبه فيه الرئيسي فى أى لحظة والذي تتوجه شكوكه نحوه أكثر من الشك فى الرجل الواقف أمامه. ومن خلال لقطة قريبة Close UP نرى نصف وجه المفتش , بينما يغطى النصف الآخر ظهر الرجل الذى يتم إستجوابه. ومن ثم فإن حركة عين المفتش ما بين الرجل وبين الشارع حركة سريعة متتالية تكتسب تأثيراً تعبيرياً كبيراً فى نقل مشاعر القلق والتوتر لدى المفتش فى هذه اللحظة .وفى فيلم بعنوان نيفادا سميث Nevada Smith - من أفلام الغرب الامريكى, يقتفى بطل الفيلم (ستيف ماكوين) اثر احد القتلة للانتقام منه.. ويعلم انه فى فندق فى إحدى القرى , فيتجه إلى هناك للبحث عنه , ويدخل إلى مكان البار ليسأل البارمان عن حقيقة وجود الرجل بالمكان.. إلا ان البارمان ينفى وجوده.. ويستشعر ستيف ماكوين انه يكذب خوفاً من القاتل لما له من سطوة شريرة قد تصيبه بالأذى .. ويقترب ستيف من البارمان ويمسكه من صدر قميصه فى حركة تهديدية كي يجبره على الإفصاح عن الحقيقة .. ويبدو وجه الرجل فى حجم قريب Close up يشغل معظم الصورة يعكس خوفه من ستيف ويرفع نظرته فى خوف الى أعلى حيث السلم المؤدى إلى غرف النوم ثم يخفضها فى اتجاه ستيف .. وكأنه يشير الى مكان القاتل المطلوب . ويفهم ستيف على الفور من حركة عين البارمان ما اراد ان يفصح به فى صمت بدلا من الكلمات التى لو نطق بها قد تكلفه حياته ..2 : وفى مجال توظيف حدود الصورة لخلق عنصر التشويق , فإن المخرج عندما يسعى الى تحقيق ذلك يبدأ بتوجيه اهتمام المتفرج الى شئ ما خارج الكادر , ويؤجل الإفصاح عنه للحظة او لحظات بينما تتصاعد رغبة المتفرج نحو رؤية هذا الشئ , وتصبح لحظة الكشف عنه بمثابة إشباع لهذة الرغبة . وقد تؤدى فى نفس الوقت الى التأكيد على معنى درامى أو رمزى هام ففى فيلم (شاي وحنان Tee and Sympathy ) تدور أحداثه فى إحدى الكليات الأمريكية ذات نظام الإقامة (المبيت) الداخلية للطلبة وبعض أعضاء هيئة التدريس فى فيلات متناثرة بالموقع . وتقوم زوجات أعضاء هيئة التدريس برعاية الطلبة اجتماعيا لتعويض ابتعادهم عن أسرهم . وتتركز الأحداث حول أزمة طالب رقيق الأحساس لا يستطيع التأقلم مع زملائه فى عبثهم المراهق . وتشعر زوجة المدرس التى ترعاه اجتماعيا انه يكن نحوها شعورا مختلف رقيق يتجاوز نطاق الرعاية الاجتماعية, وتخشى فى نفس الوقت ان تصوب لة مفهومه الخاطئ حتى لا تحطمه نفسيا . ولكى يجسد المخرج مأزق الزوجة فى هذا الموقف فإنه يصورها لحظة تأزمها وهى فى غرفة المعيشة بمنزلها تنظر بعيد خارج الكادر بينما تتحرك مركزة نظرها على شئ ما باهتمام واضح وترتد الكاميرا أمامها مع حركتها حتى يظهر فى مقدمة الصورة طاقم فضي لتناول الشاي , وتنظر الزوجة الى الطاقم بينما تمتد يدها لتمسح على إبريق الشاي فى حركة رقيقة .. ويرمز طاقم الشاي الى إلتزام الزوجة بواجب الرعاية الاجتماعية فى مواجهة أزمتها بخصوص الطالب .وفى فيلم بعنوان (الهروب الكبير) يثور جمع كبير من الأسرى البريطانيين والأمريكيين داخل معسكر اعتقال المانى خلال الحرب العالمية الثانية .. ويعبرون عن وجهتم فى حركة جماعية الى الأمام بينما يتركز نظراتهم الى أعلى , نحو شئ ما خارج حدود الصورة .. وترتد الكاميرا أمام حركتهم وهى ترتفع الى حيث ينظرون .. وتدريجيا يظهر بمقدمة الصورة استحاكمات الأسلاك الشائكة التي تعلو سوراً ضخما هو سور المعتقل , ومع ظهور هذه الأسلاك فى مقدمة الصورة تتوقف حركة الأسرى وحركة الكاميرا فى تعبير يرمز إلى اليأس الممتزج بالرغبة الجامحة فى الهروب من المعتقل بشكل أو بأخر.
3 : وفى مجال توظيف حدود الصورة فى خلق تأثير " المفاجأة " فإنه يقوم أساساً على تقديم المخرج لوضع أو موقف ما ليستقبله المتفرج بمعنى محدد , بينما يكون قد أخفى خارج حدود الكادر عنصراً ما يتناقض مع ذلك المعنى ويترتب على ظهوره ما يُحدث المفاجأة المستهدفة . وفى هذا الخصوص يقدم لنا رودلف ارنهايم فى كتابه "فن السينما " مثالاً معبراً من فيلم من أفلام شارلي شابلن الصامتة بعنوان " المتأنقون" حيث يظهر شارلي فى لقطة قريبة متوسطة وهو فى ملابس سهرة فى حفلة ما. وما أن يطمئن المتفرج إلى مضمون الصورة الذى يبدو بسيطاً وعادياً إلى أقصى درجة , يتم الكشف فجأة عما يقع أسفل حدود الصورة ويتضمن معلومة مناقضة لبداية اللقطة , وهى أن شارلي يقف بلا بنطلون ... ويستطرد ارنهايم فى تفسير هذا الاستخدام بأنه يقوم على مبدأ يسمى " الجزء بدلاً من الكل" بمعنى انه تعرفنا على ماهية الأشياء فإنه ليس من الضروري دائماً أن نراها بكاملها , فالجزء من أى شيء يمكن أن يكون فى كثير من الأحوال كافياً للدلالة على الكل... وفى فيلم " الحرارة البيضاء" يقوم بطل الفيلم " جيمس كاجنى " بالتخطيط مع فتاته للهروب من أمه التى أطبقت قبضتها عليه منذ الصغر مما دفعه الى سلوك طريق الإجرام , وهو يرغب الآن أن يبدأ حياة جديدة بعيداً عن الأم . والمشهد يدور ليلاً فى شرفة منزل الأم ذى الطابق الواحد .... وما أن يتفق " كاجنى " مع فتاته على كيفية الهروب وتوقيته, فإنه يدعو فتاته للدخول إلى المنزل طلباً للنوم ... وبينما يسيران فى هدوء تتوقف الكاميرا عند شباك فى خلفية الصورة بينما تظهر الأم خلفه ودون أن يشعرا بوجودها . ويوحى هذا الكشف بالطبع بأن الأم كانت هناك تستمع فى تلصص إلى تفاصيل خطتهما بينما كانا يعتقدان أنها داخل المنزل تغط فى نوم عميق . وفى فيلم بعنوان " هذه الحياة الرياضية " يصور مخرج الفيلم بداية أحد المشاهد فى كادر قريب تظهر يداً قابضة على حدود عامود سرير معدني بينما تمتد نحو الذراع يد أخرى تقبض عليه فى قوة . ومن خارج الكادر نسمع زفرات خفيفة ... وتوحي اللقطة ككل بعلاقة غرامية بين بطل الفيلم والأرملة التي تؤجر له إحدى غرفات منزلها . وذلك بعد أن كانت قد صدت محاولاته لإقامة مثل هذه العلاقة . ثم يفاجئنا المخرج فى النهاية بتوسيع مجال الرؤية فنكتشف أن اليدين للبطل نفسه وقد قبض بالأولى على عامود السرير وقبض بالثانية على ذراعه الأخرى بينما يزفر فى معاناة . ويتجلى فى هذا التوظيف براعة الاستناد على مبدأ " الجزء بدلاً من الكل " للإيحاء بموقف لم يحدث على الإطلاق . رابعاً : الحركة فى الحياة الواقعية , اعتدنا النظر إلى حركة الأشخاص والأشياء كأمر منطقي لا يترك فينا إحساساً جمالياً . أما رؤية الحركة من خلال الصورة السينمائية فإنه ينقلها من مجال الرؤية الاعتيادية على مستوى الواقع إلى مجال الرؤية الجمالية . وتصبح الحركة داخل إطار الصورة ممثلة لوسيلة سينمائية يوظفها المخرج لخلق تأثيرات جمالية متعددة . وكما يقول مارسيل مارتن فى كتابه اللغة السينمائية " إن الحركة هي الحقيقة الجمالية الأولى فى الصورة السينمائية " . ومع ذلك فإن من متطلبات تذوق الصورة السينمائية أن نعود إدراكنا البصري على رؤية الحركة بما يجاوز مضمونها الواقعي , أى أن نراها أيضا من منظور تجريدي أو تشكيلي . ولتحقيق هذا المطلب فإنه ينبغي علينا أن ندرس الأمور الجمالية المتعلقة بالحركة داخل إطار الصورة من حيث نوعياتها وتكويناتها وأشكالها .وفيما يتعلق بنوعية الحركة فإننا ننظر إليها من خلال ثلاث نوعيات رئيسية وهي: 1- الحركة الفعلية Actual motion ويقصد بها حركة الأشخاص ( الممثلين ) وكل العناصر الأخرى التي تملك ذاتية الحركة أو تتحرك ميكانيكياً . 2- حركة الكاميرا Camera motionوالمقصود بها حركة الكاميرا فى كافة صورها , وتسمى علمياً بالحركة النسبيةRelative motion ويستند هذا الأسم إلى أن الحركة الفعلية للكاميرا إنما تتم أثناء التصوير , وحيث أن المتفرج يرى ناتج هذه الحركة وهو ثابت فى مكانه وفى غياب أى حركة فعلية تماثل حركة الكاميرا فى مكان التصوير , فإن ما يعرض عليه يمكن رصده كحركة نسبية أيضاً . فلو تحركت الكاميرا أفقياً مثلاً على مجموعة من العناصر الثابتة , من اليمين إلى اليسار , فإن ناتج هذه الحركة التي كانت فعلية أثناء التصوير, يظهر هذه الأشياء الثابتة أصلاً وكأنها تتحرك بعكس الاتجاه الذى كانت عليه الكاميرا فى الحقيقة أى يمكن أن نراها كما لو كانت تدخل الصورة من اليسار وتخرج من جهة اليمين . وبالمثل لو كانت الكاميرا قد تحركت نحو شيء ثابت ( حركة فى العمق ) , فإلى جانب إدراكنا (العقلي ) بأن الكاميرا تتحرك نحو هذا الشيء فإنه يمكن أيضاً على مستوى الإدراك البصري البحت أن نرى هذا الشيء وكأنه يتحرك نحونا من حيث أن حجمه سوف يزداد تدريجياً منتشراً فى اتجاه حدود الصورة الأربعة (مفهوم تسطح الصورة) . أما إذا تحركت الكاميرا فى حركة متابعة لشيء يتحرك فإن تأثير الحركة النسبية ينتج مما قد يتواجد فى الصورة حول الشيء المتحرك من أجسام أو تفاصيل ثابتة , مثلما فى حالة متابعة حركة الكاميرا لشخص يتحرك من اليمين إلى اليسار مثلاً بينما يظهر فى أمامية الصورة عدد من الأعمدة أو الأشجار أو قطع الأثاث .... فمع رصد حركة الشخص كحركة فعلية فإن الثوابت والتفاصيل الثابتة فى مجال الرؤية تبدو فى نفس الوقت وهى فى حالة حركة نسبية عكس اتجاه حركة الكاميرا .وعلى ذلك فإننا يجب أن نعود النظر دائماً على رؤية ناتج حركة الكاميرا من منظور يتعلق الأول منهما بإدراكنا العقلي لها كحركة كاميرا فعلية , أما الثاني فيتعلق بإمكانية رصدها كحركة نسبية . وعلى مستوى الإدراك العقلي لحركة الكاميرا ينظر مارسيل مارتن فى كتابة اللغة السينمائية إلى استخدماتها من خلال قطاعيين رئيسين : أ : يضم القطاع الأول منهما ما يسميه بحركات الكاميرا الوصفية , ويقصد بها تلك الحركات التى تنحصر وظيفتها فى دور وصفى من تفاصيل بيئة التصوير أو أبعاد المكان وجغرافيته أو الجو العام الذى يدور فيه حدث ما. ولعله أشهر الاستخدامات فى هذا الخصوص يتمثل فى حركة الكاميرا البانورامية لتقديم مكان ما. أو حركة الكاميرا الرأسية التى تكشف عن بناء شاهق أو تحدد جزء منه سيدور فيه حدث مقبل, أو تلك التي تتابع حركة شخصية ما فى دخولها إلى مكان ما أو عند التحرك فيه حركة عادية . ب : أما القطاع الثاني من حركات الكاميرا فيكسبه مارتن أهمية أكبر من القطاع الأول , حيث أن حركة الكاميرا تلعب فيه دوراً خلاقاً , ومن ثم فإنه ينظر إليها كحركة تعبيرية أو ذات دلاله درامية أو جمالية . ولعل أشهر استخدامات هذه النوعية من الحركة يتمثل فى حركة الكاميرا التي تتجه نحو شخصية ما فى لحظة تأزمها لتضع المتفرج فى حالة من التعاطف معها أو بهدف تجسيد مدلول درامي معين , أو تلك التى تتجه نحو تفصيلة ما لتكشف عن سر معين أو يراد لها أن تكون بمثابة تمهيد لفعل هام سيرتبط بها ... وكذلك حركات الكاميرا التى تبدو كباحثة عن شىء ما أو متلصصة على أمر يدور فى الخفاء , أو تكشف للمتفرج وحده عن مكمن خطر ما لا تعلم به الشخصية ( مفارقة درامية ) ...3- الحركة الناتجة عن المونتاج Editorial Motion لمزيداً من المعلومات أنظرويقصد بها نوعية من التأثير الحركي المضمر الذى يحدث نتيجة للقطع من لقطة إلى أخرى , أى عند نقطة اتصال نهاية لقطة ببداية اللقطة التي تليها . فمع كل قطع يحدث ما بين طرفين تغير ما بدرجة أو بأخرى وذلك فى أى من العناصر التشكيلية أو بعضها أو كلها . كما قد يحدث تغير فى موقع نقطة (مركز) الانتباه من حيث مكانه داخل إطار الصورة ما بين نهاية اللقطة الأولى وبداية الثانية , كأن يكون التركيز فى أولاهما فى يمين الصورة بينما يتحول مع الثانية فى أقصى اليسار . فمثل هذه التغيرات تجبر العين دائماً على إعادة تكييف الإدراك البصرى فى لحظة الانتقال بين اللقطتين . ويعتبر إعادة التكييف هذا بمثابة حركة مضمرة تدركها العين , بصرف النظر عن عدم رصدها لشكل حركى صريح يمكن التعرف عليه ... من ناحية أخرى فإن الحركة الناتجة عن المونتاج قد تعمل كجسر بصري يربط بين أشكال حركية صريحة سواء بالتوافق أو بالتضاد, وذلك عندما يتم القطع بين حركتين تتحركان فى نفس الاتجاه ( توافق ) , أو حركتين متضادتين مما يخلق حساًً أقرب إلى التصادم..والحركة فى تكوينها قد تكون حركة بسيطة عندما تتكون من موضوع واحد , أو حركة مركبة عندما تتكون من عنصرين أو أكثر , وقد تكون حركة بسيطة - مركبة عندما تكون من أكثر من عنصر إلا أى عناصرها تتحرك فى نفس الاتجاه وبنفس الإيقاع . أما من حيث الشكل فالحركة قد تكون مستقيمة ومباشرة أو تكون انسيابية عندما تأخذ مساراً منحياً أو شبه دائري .وقد تكون حادة عندما تتغير بسرعة بشكل زاوية أو بشكل زجزاجى ,أو تكون رتيبة عندما تتكرر بشكل واحد مثلما حركة البندول أو المرجيحة . كما تكون الحركة معقدة إذ اتخذت شكلاً متعرجاً بلا نموذج محدد أو عندما تتكون من عنصرين أو أكثر فى شكل حركات متعارضة أو متنافرة . وبشكل عام فإن مخرج الفيلم يعطى أهمية خاصة للحركة الفعلية بحيث تحقق له هدفين رئيسين , أن تدعم أو تجسد أو تفسر الدلالات الدرامية من ناحية . وأن تضفى على الصورة حساً جمالياً مؤثراً. ولتحقيق هذا الهدف الأخير فإنه ينبغي الاهتمام بأن تبدو الحركة منطقية ومبررة وليس لمجرد تحريك الأشخاص أو الأشياء - فالحركة للحركة ذاتها تؤدى إلى إصابة الإيقاع بالتعثر والاهتزاز كما أنها قد تشتت الانتباه. خامساً : الإضاءة تتركز وظيفة الإضاءة على مستوى الواقع , فى تمكيننا من رؤية الأشياء بوضوح كاف. وهذا برغم أننا قد نستهدف أحياناً الحصول على بعض التأثيرات الضوئية الخاصة مثل توظيفها لإضفاء إحساس بالهدوء والاسترخاء , أو بالعكس لخلق شيء من الإثارة ., أو توظيفها تجارياً لجذب الانتباه ..الخ . إلا أن مثل هذه الاستخدامات تظل فى نطاق الاستثناء , والذى لا يطغى على حقيقة أن ضرورة الإضاءة فى حياة الإنسان هى لتمكينه من الرؤية حتى يمارس حياته الطبيعية بشكل مريح سواء فى ظل ظروف الإضاءة الطبيعية النهارية أو الإضاءة الصناعية ليلاً . وفى السينما تبدأ وظيفة الإضاءة من نقطة مشابهة لدورها على مستوى الواقع , فلا بد من تسجيل الصورة بما يجعل المتفرج يرى تفاصيلها فى وضوح إلا أنه لكون السينما فناً فإن توظيف الإضاءة يتجاوز عنصر الوضوح نحو مجال متسع من تكوين التأثيرات الضوئية الجمالية كى تدعم الدراما ودلالاتها وتؤثر فى وجدان المتفرج بمشاعر متباينة . وبينما تبدو فرصة توظيف التأثيرات الضوئية فى المناظر الخارجية النهارية محدودة من حيث أن الصورة تخضع أساساً لظروف الإضاءة الطبيعية , فإن ممارسة فنية الإضاءة وتأثيراتها تجد الفرصة واسعة فى المناظر الداخلية والليلية حيث يتم تصميمها وتكوينها بالاعتماد على مصادر الضوء الصناعية الخاصة , وبما يمكن مدير التصوير من الحصول على كافة التأثيرات الضوئية التي يستهدفها. يقول مارسيل مارتين فى كتابة " اللغة السينمائية " أن بداية تنبه السينمائي لفنية الإضاءة وقيمتها الخلاقة ترتبط بظهور الاتجاه التعبيري فى السينما الألمانية فى السنوات الأخيرة من العقد الثاني . ويخص بالذكر فى هذا الخصوص فيلم " مقصورة الدكتور كاليجارى " فى عام 1919 والذي لعب دوراً مؤثراً فى هذا الاتجاه . فقد قدم تشكيلات ضوئية غير مسبوقة اعتمدت على إبراز التباينات الحادة بين مناطق النور والظلال الكثيفة . وبرغم أن هذا التوظيف بدا بعيداً عن الواقعية إلا أنه أدى وظيفته الفنية بفاعلية من حيث توافقه مع موضوع وروح الفيلم الذى رآه المتفرج من وجهة نظر أحد المختلين فعلياً خلال فترة علاجه بمصحة للأمراض العقلية .فبرغم عدم واقعية إضاءة الفيلم إلا أن توظيفها بهذه الكيفية لفت الأنظار بقوة إلى منطقة جديدة خلاقة ظلت مجهولة لأكثر من عشرين عام منذ بداية السينما . وسرعان ما بدأت السينما العالمية فى تقليد أسلوب السينما الألمانية - وكانت السينما الأمريكية سباقة فى اجتذاب عدد من أبرز فناني السينما الألمانية من مصورين ومخرجين ليطبعوا أفلامها بهذه الاتجاهات الجديدة . إلا أن الإسراف فى هذا الاتجاه حول معظم الأفلام التى اعتمدت عليه , إلى اكتساب صورة من المبالغة والافتعال , فقد كان تحقيق مثل تلك الأساليب الضوئية يغرى السينمائي بعدم احترام مصادر الضوء فيما ينبغي أن توحي به من صدق وواقعية تتفق مع المصدر الضوئي المفترض وجوده فى المكان فى كل توقيت ضوئي معين . وقد أدى الإسراف فى هذا الاتجاه إلى توجيه النقد لها ووصفها بصفة الإضاءة الميلودرامية . ومع تنبه السينمائي لمثل هذا النقد بدأ يصحح استخداماته بالموازنة بين ما يسعى إلى تحقيقه من تأثيرات ضوئية , ومصدر أو مصادر الضوء المفترض وجودها فى المكان فى توقيت ضوئي معين .وفى الممارسة العملية لتصميم الإضاءة فإنها ترتبط مبدئياً بنوعية الفيلم من حيث كونه تراجيديا أو كوميديا -رومانسي أو من أفلام الجريمة - إجتماعى أو سياسي ..الخ . وبصفة عامة فإن تصميمها يتراوح ما بين كثرة الظلال والتباينات بين الصورة والظل ( تراجيديا ) ويتدرج فى اتجاه الإضاءة الساطعة الخالية من الظلال (الكوميديا) ... فبين إضاءة التراجيديات والكوميديا تتنوع أشكال الإضاءة وفقاً لطبيعة الفيلم , كما أنها تتنوع بدرجة أو بأخرى داخل الفيلم الواحد وفقاً لطبيعة كل مشهد ...وتكتسب الإضاءة فى الفيلم أهميتها من تأثيرها الجمالي على وجدان المتفرج والذي يتجاوز معايشته لها على مستوى الواقع بفارق كبير . ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى اختلاف درجة حساسية العين البشرية فى رؤيتها لأضواء الواقع فى تدريجاتها ما بين الضوء الساطع والظلام - عن درجة حساسية عدسة الكاميرا ومادة الفيلم الخام . فالعين البشرية تتمتع بالقدرة على التمييز بين عدد كبير من التدريجات الضوئية يفوق ما تقدمه له الصورة السينمائية . فالصورة السينمائية تبدو فى انتقالها من درجة ضوئية إلى أخرى كمن تقفز فوق المسافات التى تقع بينهما , الأمر الذي يجعل التباين بين درجة وأخرى فى الصورة أكثر حدة مما نراها على مستوى الواقع - فإذا أضفنا إلى ذلك حقيقة تسطح الصورة التى تؤكد أن الكائنات , تظهر على سطحها متجاورة أكثر من كونها على أبعاد مختلفة فى العمق , فإن هذا يفسر لنا قوة تأثير التشكيلات الضوئية فى وجدان المتفرج . وفى هذا النطاق يشير رودلف ارنهايم فى كتابة " فن السينما" إلى أن الإضاءة فى الصورة السينمائية يمكن أن تجعل الشيخ يبدو شاباً أو العكس , وأن تجعل المكان يبدو واسعاً أو ضيقاً , دافئاً او بارداً ... كما يمكن أن تثير فينا دلالات رمزية مرتبطة بخبرتنا الواقعية فتخلق فينا مشاعر متباينة مثل : الحب ..النفاق .. الخير .. جمال الحياة , أو على النقيض مثل : الشر .. الغموض ..التوتر..الموت ..ويرتبط بالدرجات الضوئية فيما بين النصوع والقتامة , ما تتميز به ملابس الشخصيات وعناصر الديكور أو موقع التصوير من درجات لونية بين الأبيض والأسود فتلعب دوراً مكملاً للتأثيرات الضوئية وفقاً للمساحة التي يشغلها أى منها فى إطار الصورة , فيزيد التأثير كلما كان فى لقطة قريبة ويقل فى اللقطات البعيدة . فإلى جانب الفارق الحاد فى التأثير ما بين رداء أبيض ورداء أسود من الناحية العامة, فإن درجة تأثير أى منهما تتوقف على موقعه فى إطار الصورة فى لحظة معينة . فهناك فرق كبير بين وضع شخصية فى رداء ابيض بمقدمة الصورة بحيث تشغل نصفها أو ثلثيها وبين أن تستقر فى أبعد نقطة فى العمق فلا يعدو تأثيرها مجرد بقعة بيضاء . ففى فيلم بعنوان "المبعوث المنشورى" نشاهد بطل الفيلم " لورانس هارفى " الواقع تحت تأثير عملية غسيل مخ كان قد تعرض لها أثناء أسره فى الحرب الكورية قبل عودته إلى وطنه ( الولايات المتحدة ) ..ونرى لورانس وهو يتقدم داخل منزل مخدومه فى العمل كي يقوم باغتياله بمسدس كاتم للصوت ..ويبدو فى خطواته كما لو كان يسير تحت تأثير أقرب إلى التنويم المغناطيسى غير واعى بفداحة العمل المقدم عليه .. ويخطو لورانس إلى داخل غرفة نوم مخدومه الذى كان قد أستقر فى سريره استعدادا للنوم ...ويبدو السرير فى نهاية الغرفة بلون فرشه الأبيض ...وبينما يسأل المخدوم لورانس فى ارتياب عن سبب دخوله إليه, فإن لورانس يتجاهل السؤال ويستمر فى حركته نحو الضحية ...ويختار مخرج الفيلم وضعاً للكاميرا بحيث نبدأ فى رؤية لورانس من ظهره بملابسه السوداء فى مقدمة الصورة بينما يظهر السرير بمساحته البيضاء ...ومع استمرار لورانس فى حركته ينغلق الكادر تدريجياً باللون الأسود الصادر عن ملابسه فيطغى على المساحة البيضاء(السرير) حتى تختفى تماماً مع سيادة اللون الأسود الذى يغطى كل مساحة الكادر ..ويصاحب الصورة كرشيندو موسيقى ...وتنتهي اللقطة بهذه الكيفية دون أن نرى لحظة إطلاق الرصاص التي تصل إلى مشاعرنا من خلال ابتلاع اللون الأسود للون الأبيض بتأثير أقوى كثيراً من مشاهدة عملية الاغتيال بشكل مباشر . ويمتد نطاق التعامل مع التأثيرات الضوئية إلى نطاق مصادر الضوء الذى نعايشها على مستوى الواقع وترتبط فى مشاعرنا بأحاسيس معينة ..وذلك مثلما فى حالة أضواء البرق ...ضوء فنار على البعد ...ضوء نار المدفأة أو النار بشكل عام ..إنعكاسات الضوء من نوافذ قطار يسير ليلاً ...أضواء كشافات السيارة ليلاً ...ضوء مصباح يتأرجح فى جو عاصف ..الخ. ففى فيلم " نفوس معقدة Psycho " لألفريد هيتشكوك تكتشف الفتاة شقيقة "ماريون " التى هربت بالمبلغ المالى وقتلها "نورمان " فى الحمام ...تكتشف مكان القبو الذى وضع فيه "نورمان " جثة أمه ( الهيكل العظمى )... ونرى الهيكل من ظهره وقد اكتسى بملابس كاملة مستقراً فوق كرسى بالمكان ... وتتجه الفتاة نحو الهيكل معتقدة أن الأم ما زالت على قيد الحياة ... وما أن تكتشف الحقيقة حتى تصرخ ويرتفع ذراعها فى الهواء فيرتطم كفها بمصباح الغرفة المنخفض بشكل ملحوظ فيتأرجح ما بين عمق الصورة ومقدمتها كما ينعكس ضوءه فى حركته المتأرجحة على جمجمة الهيكل العظمى فيجسد صدمة الفتاة إزاء اللحظة ...
طبيعة فن السينما والتليفزيون :: الفصل الأول 2
طبيعة فن السينما والتليفزيون
طبيعة فن السينما :نشأت فنون الرقص , والغناء , والدراما , والأدب , والموسيقى , والفن التشكيلي نشأة خاصة , فقد كانت نشأتها بين النخبة الممتازة من الناس . فلم يمارسها ولم يتمتع بها إلا الأرستقراطيون . أما السينما فقد نبعت من صالات التسلية البدائية فكانت نوعاَ من أنواع التسلية واللهو . ولعل نشأتها المتواضعة جعلت الخاصة تتجاهلها في أول أمرها , ولكن سرعان ما استحال استمرار هذا التجاهل , إذ أن إقبال المتفرجين وضحكاتهم أخذت ترتفع , فأخذت السينما تكتسح ما يقف أمامها في قوة الطوفان الجارف حتى صارت من أهم وسائل الاتصال السمعية والبصرية في القرن العشرين . وللموضوع جذوره . . فقد وصف ليوناردو دافنشي في مذكراته التي لم تنشر , والتي جاء ذكرها بالتفصيل في كتاب " السحر الطبيعي " لمؤلفه جيوفاني باستاد بللا يورتا , والذي نُشر عام 1558 أصل الصورة السينمائية بقوله " إذا أنت جلست في حجرة دامسة الظلام في يوم مشمس , ولم يكن بالحجرة سوى ثقب بمقدار رأس الدبوس في أحد جوانبها , استطعت أن ترى على الحائط المقابل للثقب , أو على سطح أخر في الغرفة , ظلالاَ أو خيالات للعالم الخارجي : شجرة , أو رجلاَ , أو عربة عابرة .
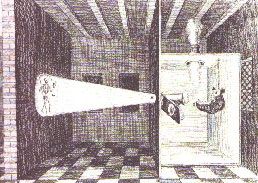
وما أشبه جماعة من الناس في غرفة مظلمة , يتطلعون في دهشة وعجب إلى الخيالات المتحركة , بجماعة من المتفرجين في قاعة مظلمة يشاهدون شاشة السينما , وهكذا كما نرى بدأت السينما بالصور فقط .وبقوة الصور لم تجد السينما الصامتة صعوبة في إرضاء جماهير ضخمة .
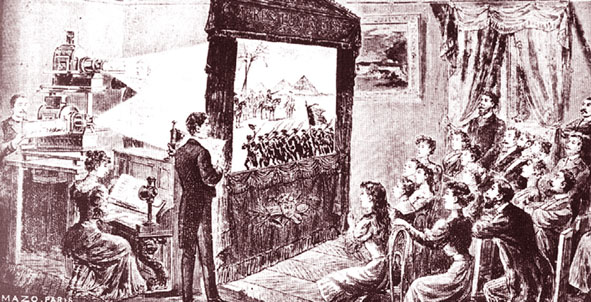
وفى أول الأمر حاول السينمائيون أن يصوروا للمتفرجين المسرحيات برمتها , وكما هي , بل والكاميرا ثابتة على بُعد محدد . وكان الممثلون يواجهون المتفرجين مواجهة تامة تماماَ كما يفعلون على خشبة المسرح . بل إن المُشاهد كانت تبدأ بدخول الممثلين وتنتهي بخروجهم . كانوا يريدون الظفر بما في المسرح من قوة ناتجة عن وجود الممثلين بلحمهم وشحمهم , فقد كان عرض العلاقات الإنسانية في المسرحيات المصورة يثير في نفس المتفرج الشعور بالتوتر ويغريه بالتعرف على نفسه , وهو المفتاح الذي يفتح مغاليق الانفعال . فقد كانت مشكلة السينما الرئيسية هي عدم وجود متفرجين كما في المسرحية . وبعد عدة سنوات تبينت السينما أنها تستطيع أن تفعل أكثر من تصوير المسرحية , بل أنها تستطيع أن تحول ضعفها إلى قوة . فعندما أدخل جريفث " اللقطة القريبة " , كانت دهشة المتفرجين كبيرة إلى حد دعاهم إلى الصياح " أين أرجل هذا الوجه ؟. ولكن السينما , مضت تخلق وتثبت تقاليدها الخاصة , والتي هي أشد ترابطاَ وثباتاَ من تقاليد المسرح , ثم كان تغير مكان الرؤية , فبعد أن يصور جزء من مشهد من زاوية معينة , يصور جزء أخر من زاوية أخرى وكان الخوف من ذلك أن يشعر المتفرج بالدوار - ولكن المتفرج لم يُبد أي تبرم على إعفائه من القيود البدنية المفروضة على الجسد , وقبل على الفور دور المتفرج المتحرك . . ينظر من جانب ثم ينتقل لينظر من الجانب الآخر , وينظر من بعيد ثم من قريب , مرة من داخل الغرفة إلى الخارج , ومرة أخرى من الخارج إلى داخل الغرفة , مرة من فوق كتف البطلة , ومرة أخرى من فوق كتف البطل . وهكذا تحولت نقطة الضعف ( أي عدم وجود متفرجين ) , إلى نقطة قوة ( أي عنصر الحركة ) . كانت الحركة الذاخرة بالمعنى تأسر الاهتمام , بل أنها تخلق لدى المتفرج الشعور بالتوتر والانفعال .ومع أن السينما كانت تتصف بالقوة منذ بدايتها , ولكنها عندما أصبحت ناطقة كبُرَ أتساع أهميتها كوسيلة تعبير . فالكلمات تستطيع أن تقوم بتوضيح الحركة ومعانيها , وبالجمع بين الصور الغنية بالتفاصيل والمعاني , وبين الكلمات التي تقول بطبيعتها شيئاَ واحداً في وقت واحد , أكسب السينما قوة فريدة تعمل على إدماج المتفرج في سيل دائم من التفكير والانفعال وتجعله شريكاَ مشاركاَ إلى حد عظيم . وهكذا نراها وصلت باستغلال عدم وجود المتفرجين , إلى أن تتعلم كيف تنمي طاقتها المؤثرة في العواطف . فكثيراً من المشاهد التي كان يراها المتفرج بارعة, إنما كانت كذلك لأن المتفرج نفسه هو الذي يقوم بتمثيلها , وذلك لأن مجموعة اللقطات الغنية بالمعاني , استدرجته إلى نوع من الانفعال تصبح فيها الأدوار متبادلة بينه وبين الممثل . هكذا أصبح للسينما لغة لها أجروميتها ومفرداتها وحسناتها وبلاغتها ... حيث اللقطة هي الوحدة الأولية , ومن تراكيب هذه اللقطات تتكون المشاهد , وجمال اللقطة وانسيابها أو تصادمها مع اللقطة التالية ينتج معنى ما , يصر السينمائي أن يُشرك المتفرج معه في استنتاج هذا المعنى فيصبح دوره إيجابياَ في عملية التلقي , كما يملك السينمائي عناصر الموسيقى . . والمؤثرات الصوتية . . والإضاءة . . واللون . . والتمثيل . . والتكوين , وكلها عناصر تشكل مفردات اللغة التي يُكتب بها على الشاشة , وتشكل في الوقت نفسه قنوات الاتصال بينه وبين المتفرج عبر السمع والبصر معا . وهكذا أصبحت السينما وسيلة سمعية بصرية أساسية من وسائل الاتصال الجماهيري , تناولت كل شريحة من شرائح المجتمع وعالجت كل موضوع ووصلت إلى كل جمهور. بل أنها أصبحت تستحق أن يُطلق عليها اسم " الفن السابع " . طبيعة فن التليفزيون : وصلت السينما إلى جمهورها الواسع في بدايات القرن العشرين ولم تأخذ شكلها كفن ذو ملامح خاصة إلا في العشرينات أما شاشة التليفزيون فقد ولدت في العشرينات وانتشرت في الأربعينات كسينما على الهواء مباشرة , ولم تصل إلى البيوت إلا في الخمسينات. ومنذ البداية وكما اعتمدت السينما على تصوير العروض المسرحية , اعتمد التليفزيون على السينما , وورث كثيراً من تقاليدها , وعلاقتها بالجمهور , ثم علاقتها بالأفكار .ولو بحثنا في أساس كل من السينما والتليفزيون , لوجدنا أنها " الصورة " فشاشة السينما كالتلسكوب تفتش عن الأشياء البعيدة لتقربها , أما شاشة التليفزيون فهي كالميكروسكوب تفتش عن الأشياء الدقيقة وتحاول تكبيرها , ولذلك فهي تتيح للتلفزيوني ميزات لا يحصل عليها السينمائي , فالمتفرج يتعامل معها على أنها صديق حميم تقربه من الأحداث الواقعية , وتفيض بالانفعالات الصادقة والمشاعر النبيلة . ويقول رينيه كلير في كتابه سينما الأمس وسينما اليوم ," في الواقع أن التليفزيون يتمتع بميزتين : "الفورية" أي إمكانية بث حدث ما بثاً مباشراً , "والمودة" - أي إمكانية تقديم عرض , على ما يبدو , لمشاهد واحد ومن أجله وحده بينما يراه في الحقيقة ملايين المشاهدين المتفرقين في اللحظة ذاتها " . بل إنه يمثل ثورة أعظم في ميدان الاتصال البشرى من السينما نفسها . ومنذ ظهور التليفزيون أُعيد تصميم غُرف الجلوس , وظهرت في الأسواق كراسي خاصة له , وموائد صغيرة للأكل أثناء مشاهدته , وأطعمة مجمدة سريعة التجهيز. واستطاع التليفزيون أن يَشُد إليه اهتمام الناسُ بدرجةٍ هائلة عندما نقل إليهم سلسلة من العروض الحية الفورية التي حولت هذا الجهاز من لعبة غالية الثمن إلى ضرورة حقيقية . فقام بنقل المباريات الرياضية المهمة , والمسرحيات والأوبرات , وحفلات الموسيقى , والباليه , وهكذا أتاح للملايين فرصة الاستمتاع بما كان يقتصر على القلة المتميزة التي تستطيع أن تدفع ثمن تذكرة الدخول إلى الملعب , أو دار الأوبرا . ولم تقتصر مهمته على ذلك فقد قام بنقل مباشر للأحداث , التي لم يكن يحلم المتفرج بأن يراها إلا بعد حدوثها بوقت يسمح بتحميض الفيلم السينمائي وطبعه وعمل المونتاج له . ولكن وبشكل فوري نقل للمشاهد في بيته حادث اغتيال قائد الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج , ثم غطى أهم حدث في الستينات وهو نزول أول إنسان حي على سطح القمر, لقد نقل كل هذه الأحداث فور وقوعها إلى المشاهد في غرفة الجلوس وغرفة النوم وفى المطبخ أو حيث يوجد جهاز التليفزيون الخاص به .
كان التليفزيون يعرف أن من يريد أن يتحدث بلغة من اللغات عليه أن يتعلم قواعد النحو الخاصة بها , وكان يعرف أن مفتاح الطريق إلى الجماهير الكبيرة , وإلى اكتساب جماهير جديدة , هو التعرف الانفعالي, وهذا معناه الاعتماد على الدراما أي التحدث إليهم بلغة مفهومة . ومع أن التليفزيون استفاد من السينما لغتها لتكون لغته هو أيضاً , فاللقطة بأحجامها المختلفة , ووسائل الربط بين هذه اللقطات المختلفة واحدة أيضاً والصورة تنتقل عن طريق عدد من الكاميرات . والتي لكل منها إمكانيات واسعة جداً في الحركة والقرب والبعد والارتفاع والانخفاض . وهناك الإضاءةُ التي لا تلعب فقط دوراً في إبراز الصورة ولكنها تستطيع أيضاً تجسيد الحالة النفسية للشخصيات والمُعَاونة في رسم الجو العام للقطة أو المشهد , بالإضافة إلى إمكانيات المونتاج والمؤثرات الصوتية . إلا أنه عرف أنها تشكل فقط أساساً جديداً للغة معالجة درامية خاصة به ,. تختلف تماماً عن لغة المعالجة الدرامية في السينما , عنها في المسرح حتى أن الناقد آلان بريان يقول : إن الدراما التليفزيونية يتيمة جاءت ثمرة طلاق أبويها المسرح والسينما , ويجب على التمثلية التليفزيونية ولها عينا أبويها وأُذنا أُمها وفمُها الخاص - أن تكون قادرة على تحقيق قوة فردية مثيرة . ويلخص إريك بارنو هذا الاختلاف في كتابه الاتصال بالجماهير بقوله : عندما بدأ السينمائيون يعرضون الأفلام على شاشة التليفزيون تبينوا أن عليهم , أن يزيدوا من اللقطات القريبة المكبرة وأن يقللوا من اللقطات البعيدة . . فالفيلم السينمائي يُعرض على شاشة كبيرة عريضة . . أما في التليفزيون فالمتفرج يجلس قريباً من الجهاز . . كأنه يجلس إلى صديق . ولذلك كان على الفنان التليفزيوني التركيز والاقتراب بهدف الوصول إلى العمق لتحديد طريقة تلقي المتفرج وتذوقه وتوجيه انتباهه . وحتم ذلك على الدراما التليفزيونية أن تستمد مادتها بطريقة مباشرة من الحياة فهي فن إنساني يرتبط بمشاكل الحياة الاقتصادية والاجتماعية,والسياسية,والدينية,والأخلاقية. كان عليها أن تحذف التفاصيل التي لا أهمية لها في تطور الأحداث وبلورة الشخصيات , وكان على حركة الكاميرات ,والممثل , والتكوينات أن تكون نابعة من داخل الموضوع وموظفة لتحقيق غرض درامي محدد وإيقاع جيد , حتى تستطيع أن تتوغل بلا استئذان إلى عقل وقلب المشاهد . حتى أن روبرت فريزر المدير العام لهيئة التليفزيون البريطانية يقول : يتم التوصيل بمستويين - هما المستوى العقلي حيث تدور المعرفة والآراء في المجتمع , والمستوى العاطفي حيث يتولد الشعور بالعطف على الآخرين . . والتليفزيون قوة رهيبة في كلا المستويين .وفى رأى أُسامة أنور عكاشة كاتب السيناريو المصري أن النص الدرامي في التليفزيون لا يختلف عن النص الدرامي في المسرح ,أو في السينما من أنهما يعتمدان قواعد درامية واحدة وهى القواعد الأرُسطية من قواعد الدراما الكلاسيكية . ولكن الاختلاف يأتي من طول العمل ,أي أنه إذا قَصُر يُصبح سهرة في التليفزيون تأخذ تقريباً حيز المسرحية , وإذا طال يأخذ شكل مسلسل من سبع حلقات, أو عشرة ,أو عشرين حلقة ,أو أكثر حسب ما يقتضي الموضوع وهو تكرار لشكل ألف ليلة وليلة ,أي أن شهرزاد تحكى لشهريار كل ليلة وعند جزء معين تعمل قفلة الحلقة وتعلقه لليوم التالي , وهذا شيء الارتباط به متغلغل قي المثيولوجي الخاص بنا وفى فولكلورُنا , أي الحدوتة التي ترويها ستى وستك للأطفال قبل النوم .ومن هنا نرى أن الدراما التليفزيونية تأخذ عدة أشكال منها : المسلسل , والسلسلة , والتمثيلية التليفزيونية . والموضوع هو الذي يفرض الشكل الذي يُقدم به , حتى أن أُسامة أنور عكاشة يتساءل : كيف أَكتُب مسلسل " ليالي الحلمية " في فيلم سينمائي وكيف أَكتُب فيلم " كتيبة إعدام " في مسلسل تلفزيوني..هنا يتوقف كلام الكاتب.ولكن الفارق الأساسي بين دراما السينما ودراما التليفزيون ،هو أن الأولي تعتمد الصورة أساساً لها أما دراما التليفزيون فتعتمد على الحوار أولاً وأخيراً ، فإذا كانت السينما قد ورثت المسرح ، وتخلصت من سلبياته التي لا تلائمها ، فقد ورث التليفزيون الإذاعة ، ليتلاءم وجو البيوت ، وربّات البيوت . فالكاتب السينمائي من السهل أن ينجح إذا تحوّل للكتابة التليفزيونية ، بخلاف كاتب التليفزيون الذي يكتب للسينما ، فإنه سيحمل معه ما يمكن أن نطلق عليه .. الفيلم الإذاعي . والمسلسل ,كل حلقاته مُتَصٍلة وكل شخصياته واحدة ويتم تطوير الصراع والشخصيات منذ الحلقة الأولى حتى نهاية الحلقة الأخيرة ,ومع ذلك فكل حلقة تُمثِل دراما صغيرة كاملة وتتوقف في أكثر الأماكن إثارة للاهتمام , وينتظر المتفرج بفارغ الصبر الحلقة التالية ليعرف كيف تطورت الأحداث . وفى رأى أُسامة أنور عكاشة أن كل حلقة يجب أن يكون متحقق فيها القواعد الدرامية, صحيح أنك مش مطلوب أن تصل إلى الحل في نهاية كل حلقة , إنما يبقي هناك تنمية للحدث من بداية الحلقة إلى أخرها , ويبقى هناك تصاعد في المشهد باستمرار , وهو ما يحقق السيطرة على المتفرج , لأنه سيخاف أن يتحرك أو يبعُد عن التليفزيون حتى لا يفوته شيء مهم " . أما السلسلة ,فتكون حلقاتها منفصلة أي أنها بمثابة تمثيلية مستقلة لها بداية ووسط ونهاية , حيثُ تعتبر الحلقة الواحدة منهاعملاً درامياً كاملاً , لأن كل حلقة تبدأ ببداية جديدة ليست لها علاقة بنهاية الحلقة التي سبقتها , والعلاقة الوحيدة التي تكون بين الحلقات هي وجود شخصية رئيسية تقوم بالبطولة في كل الحلقات , أو أن الموضوع الأساسي في كل الحلقات واحد , وهى هنا قريبة الشبه بالفيلم السينمائي أي أن الحدث يتصاعد حتى يصل إلى الذروة الرئيسية مع نهايتها . وأخيراً ما يهم هو الاستحواذ على الانتباه والاهتمام, وإثارة الانفعالات العميقة ل عملية التعرف لدى المتفرج .ويلخص ذلك مارتن أيلسن فلي كتابه عصر التليفزيون حيث يقول : إن التليفزيون في جوهره وسيلة درامية . ولكن يجب أن يكون عائلياً إلى حد كبير، مفهوم للجاهل ,والمتعلم ,والمثقف لأنه أصبح شريكاً بالقوة في حياتنا العائلية , بل وفى كل جوانب حياتنا الفردية ,والاجتماعية , يتدخل في كل شيء , ويترك بصماته الواضحة على قيمنا وسلوكنا وعادتنا واتجاهاتنا وأفكارنا . وفى النهاية أستطيع أن أقول إن التليفزيون يلعب دوراً هاماً في حياة المجتمع الحديث . ويوزع أدواره المختلفة الهامة في حياتِنا بوجهتها الاجتماعية , ومعناها الثقافي . ومن وجهة النظر الجمالية , يحتل التليفزيون مكاناً خاصاً في منظومة وسائل الاتصال الجماهيري , فلقد ظهر الراديو ولم يطرح أحداً سؤلاً جديداً حول ولادة فن جديد أما اليوم فإن الكثير من المنظرين يميلون إلى اعتبار التليفزيون فناً مستقلاً جديداً بل أن بعضهم أطلق عليه " الفن الثامن" .
طبيعة المتفرج والفرجة
طبيعة المتفرج السينمائي والتلفزيوني : خلق الله الإنسان وجعل له خمس حواس , وميزه بالعقل والذاكرة وأضفي عليه العاطفة والإرادة والقدرة على التخيل والحلم . . وهى القاعدة التي يقف عليها كل من الفنان والمتفرج في عِلاقتهما الجدلية عبر تأثر الفنان بالعالم حوله وتأثيره في هذا العالم . وحين يتعامل الفنان مع العمل الفني فإنه يُخاطِب في مُتفرجيه بعض الحواس مُركزاً على العقل والذاكرة وعاطفة المتفرج , وقدرته على التخيل والحلم مؤثراً على الشعور واللاشعور. فالفنان يعرِف أنه لا يستطيع أن يستولي على مشاعر المتفرج إلا إذا تأكد الأخير أن عمل الفنان يخدُم غرضاً مماثلاً بالنسبة إليه , عند ذلك يترُك العنان للانفعالات الحبيسة لديه التي ليس من اليسير انسيابها وقد يتعرف على شخصه في شخصية من الشخصيات بل أنه يتعاطف معها , حتى أنه يحدث مُشاركة وجدانية بينهم . والاتصال بين الفنان والمتفرج في السينما والتليفزيون لا يتم وجهاً لوجه , ولذلك فالفنان في حاجة إلى الارتباط بهذا الانفعال أكثر مما تحتاج إليه أي وسيله أخرى , لأنه يتوجه إلى جمهور بعيد غير مرئي . . ومع ذلك فالانفصال بين المتفرج والفنان يحافظ على خصوصية المتفرج مما يجعله يستطيع أن يفتح الباب لانفعالاته على مصراعيه , وهو يقوم بهذا العمل , عندما يكون جالساً على مقعد في منزله ,أو مُتلفعاً بظلام السينما عندها يصبح أمامه مجال كامل للتعرف في الدراما السينمائية أو التلفزيونية , ولكن الفنان يجب أن يعرف أنه يتعامل مع جمهور مختلف الأجناس والخلفيات الثقافية , فهم أُناس يعيشون تحت ظروف مختلفة إلى حد بعيد , ومن شتي الثقافات والأوضاع في المجتمع, ويزاولون مهناً متباينة , ومن ثم لهم اهتمامات ومستويات معيشية مختلفة , أي أنهم في النهاية "جمهور مجهول الهوية" . والفنان يستمد قوة نجاحه من عواطف هؤلاء الناس الكامنة , ومن خلال الدراما السينمائية أو التلفزيونية يبذل الفنان مجهود كبير مرة تلو المرة لاجتذاب انتباه هذا الجمهور ولمس عواطفه العميقة , وحثه على التطلع إلى معرفة جديدة أو تبنيه فكرة جديدة , ومهما يكن من أمر فإن البحث عن جمهور ضخم , هي الفكرة المسيطرة على فناني السينما, والتلفزيون على السواء . فهي معركة دائمة يخوضها الفنان , معركة سلاحها الصور والأصوات, ليس من أجل الحصول على الانتباه والعواطف , بل معركة تنافس حول توجيه العواطف نحو المعلومات والأفكار والأفعال . وهو يعرف أن الفن الجيد , إذا لم يحتو على فكر جيد , أو أن الفكر الجيد إذا لم يقدم من خلال فن جيد , فإنه لن يكون هناك متفرجين . حتى أن موريس ويجين يعلق بقوله " للفن والفكر قناة نافعة . . بل ربما هي الأمور الأقوى تأثيراً أو على الأقل إمكانية للتأثير وذلك بسبب ما هو ميسور لها" . طبيعة الفرجة السينمائية والتلفزيونية : بالرغم من أن هدف الفنان السينمائي أو التلفزيوني هو اجتذاب الجماهير , إلا أن اختلاف طبيعة الجمهور الخاص بالفرجة السينمائية تختلف اختلافا بينا عن الجمهور الخاص بالفرجة التلفزيونية . فالمتفرج في السينما هو الذي يختار الفيلم الذي يشاهده وقد يكون على علم بموضوع الفيلم ويعرف من هم الممثلون . وهو الذي يختار الوقت المناسب للفرجة على الفيلم , أي اللحظة المزاجية الخاصة التي يُشاهد بها الفيلم , فمن حقه اختيار وقت فرجة الفيلم , إما حفلة 10 , أو حفلة 3 , أو حفله 6 , أو حفلة 9 , وكل حفلة لها جمهورها ذو المزاجية الخاصة. وهو يشترك في هذه اللحظة المزاجية مع عدد من المشاهدين يماثل عدد مقاعد قاعة العرض، ويقول اٍريك بارنو : إن الجمهور الذي تتشابه عقلية أفراده، والذي تركزت دوافعه الداخلية في اتجاه مشترك ، يمكن أن يحقق دورة اٍتصال سريعة . وهو عندما يختار حفلة معينة ، يخلع ملابس البيت ويرتدي ملابس الخروج ويعتني بمظهره ، لشعوره بأنه ضيف على دار العرض ، وينزل من البيت ، وهو يعرف أنه يخلق فرصة اجتماعية للخروج من المنزل والالتقاء بالناس والأصدقاء ،ويركب الأتوبيس أو السيارة ثم يشتري التذكرة ، ويدخل قاعة العرض ليتفرج على الفيلم الذي اختاره وهو غير مستعد للتخلي عن رؤيته ، بعد أن تحمل كل هذه المشقة ، ثم يدخل في طقوس الفرجة نفسها التي فيها نوع من السيطرة ، فشاشة السينما بحجمها الكبير ، وبالتالي حجم الأجسام والأشياء تشعر المتفرج بالضآلة ، وهناك الظلام الذي يسود القاعة وبالتالي فهو لا يستطيع التكلم مع مَن يُجاوره ، ومن هنا يأخذ إدراك الفيلم عنده طابع الفردية . فهو يرغب في إدراك الفيلم ولكنه لا يريد أن يشعر بنفسه كعضو في المجموع أو مشارك فعال في التقبل الجماعي ، بل على العكس من ذلك يريد أن يشعر بعزلته التامة وهذا ما تتطلبه فترة العرض منه . إن حالته أقرب إلى التأمل ، والصور التي تظهر على الشاشة تستثير لغته الداخلية ، وتحدد مسار انفعالاته وتسيطر على كل انتباهه . إنه كالأصم لا يشعر بالمُشاهد الآخر .ومع ذلك فإن طريقة صف المقاعد والأجساد المتقاربة تزيد من عامل التجانس وسيادة روح القطيع فتسري عدوى الضحك أو الانفعال بسهولة يقويها استعداد مسبق لحسن التلقي . في النهاية فإن كل ذلك يساعد على انتقاله من واقع الحياة اليومية إلى واقع المبدع الفني. أما الفرجة التليفزيونية فهي تختلف تماماً ،فالجمهور لا يجتمع في مكان واحد كجمهور السينما ، بل هو موزع على أبنية عديدة قد تبلغ المليون أو أكثر وهو جمهور مختلف الأعمار والأجناس والأذواق والثقافة . والمتفرج التليفزيوني ، هو متفرج مدلل ، لأنه ليس مضطراً للفرجة ، وهو لم يتكلف مشقة الذهاب لمشاهدة العرض ، كما أنه لم يدفع ثمناً لهذه الفرجة. وهو يتفرج على التليفزيون بملابسه المنزلية على الأغلب لإحساسه بأن الشاشة الصغيرة هي ضيف على بيته . وهو في مكان مضاء ، قد يشتت الانتباه .وهو غالباً على هيئة نصف دائرة يتوسطها التليفزيون وليس في شكل صفوف . وطريقة الفرجة نفسها مفروضة عليه . ويرجع جون بنتر ذلك إلى الاتصال الذاتي الذي يحدث داخل المتفرج فيقول : عندما تشاهد التليفزيون فإن عينيك وأذنيك تستقبل المعلومات وترسلها إلى المخ . فإذا الذي رأيته أو سمعته كان مشوقاً وباعثاً على المتعة ، فاٍن نظام الاتصال الذاتي الذي عندك يعبّر عن ذلك . وبالتالي تتابعه وتوليه اهتمامك وإذا لم يعجبك ، يرسل المخ رسالة إلى عضلاتك ينتج عنها قرار بتغيير المحطة أو بالضغط على زر إقفال الجهاز . وظروف الفرجة كلها غير طبيعية ، فقد يكون المتفرج عائداً لتوه من العمل ورأسه مشحون طوال النهار ، ويجلس ليشاهد المسلسل التليفزيوني مثلاً . ويجلس حوله بعض الأصدقاء وزوجته وأولاده الذين يصرخون ويهللون . وقد يُمسك بين يديه بأطباق الطعام أو بجريدة أو بمجلة .وقد يرن جرس التليفون كل ذلك في الوقت نفسه والمتفرج في النهاية يحاول التركيز على مشاهدة المسلسل التليفزيوني. ويفسر بتنر ذلك بقوله : كما تعمل المكونات الإلكترونية في جهاز تليفزيونك على منع اٍستقبال أكثر من محطة في نفس الوقت ، فاٍن جهازك العصبي المركزي يغربل أيضاً المنبهات المختلفة كي تستطيع التركيز على تفكير لحظي واحد ـ أية محطة تشاهد ، وربما رن جرس التليفون في نفس اللحظة التي تبدأ فيها بالتفكير في تغيير المحطة . فبدلاً من الرد على التليفون قد يعطي جهاز أعصابك المركزي الأولوية إلى الرسالة التليفزيونية وقد تواصل الانتباه إليها,وببساطة شديدة قد يغلق المتفرج جهاز التليفزيون وينصرف عنه لينام . ويعلق أسامة أنور عكاشة على ذلك بقوله : لابد أن تكون الدراما قادرة على الإمساك بمتفرج التليفزيون تماماً ، لأنه سهل الفرار بعكس متفرج السينما الذي يُكمل فرجته أياً كان الفيلم الذي يعرض ، فقد يسب الفيلم بعد خروجه ، ولكنه نادراً ما يترك الفيلم ويخرج ، فهو يعتقد أنه طالما دفع ثمن التذكرة فعليه أن يتفرج على الفيلم حتى نهايته . ومن هنا كان على الدراما التليفزيونية أن تكون من القوة بحيث تمسك بهذا المتفرج ولا تجعله يفر منها . وعلى كاتب الدراما التليفزيونية أن يتمتع بالقدرة على السيطرة على موضوعه وشخصياته طوال عمل قد يستمر لمدة 10 ساعات أي ما يوازي خمس أو ست أفلام . في النهاية يجد الفنان التليفزيوني نفسه يتعامل مع متفرج متمرد بطبيعته وبطبيعة ظروف الفرجة نفسها ،متفرج عنده إحساس دائم بالتفوق على الشاشة نظراً لصغر حجمها ومع ذلك فهي شديدة الصلة به . ومن هنا حاول الفنان التليفزيوني أن تتفاعل خصائص العمل التليفزيوني مع الخطوط العريضة لشخصية المتفرج وخصائصه النفسية ورغبته في الحصول على الإشباع .. فقد حاول التركيز على قرب الصورة ـ الصورة هنا كأداة اتصال ، وليست لغة أساسية في بناء العمل الفني ـ من المتفرج ليقضي على الاٍنفصال الذي أوجدته الشاشة السينمائية ويزيد من عنصر الألفة بينه وبينها . وأصبحت الصورة عنده هي اللغة التي يخاطب بها المتفرج الذي يجيد القراءة إلى جانب المتفرج الأمي ، حتى يصل إلى أكبر عدد منهم . أصبح يحرص على تصوير برامج تليفزيونية تناسب متفرجين يجلسون في غرف استقبالهم في محيط عائلي يجمع أفراد الأسرة الصغيرة ، أو الكبيرة ، أو الأصدقاء ، أو الاثنين معاً ، وهو يعرف أن كل فرد في العائلة تحكمه مجموعة من القيم والأخلاقيات مرتبة وفق أولويات خاصة ، قد لا يكون نفس الترتيب الذي يسيطر على الفرد في محيط عائلي آخر . وهو يعرف أنه لا يستطيع أن يقدم موقفاً أو تجربة خاضتها كل أسرة ,ولكنه يقدم الموقف الذي يمكن أن تتصور أي منها أنه يمكن أن يقع لها في إطار الظروف المكانية والزمانية المعاشة . حتى أن أسامة أنور عكاشة يقول : إن الدراما التليفزيونية موجهة لجماهير عريضة جداً تبلغ الملايين . وهذا لا يتوفر لأي وسيلة فنية أخرى . وهو ما يجعل لها اشتراطات معينة في مخاطبة عقلية هذه الملايين من الجماهير المختلفة الأذواق,والميول ,والثقافات. ولذلك يجب أن تكون هناك لغة تليفزيونية تصل للجميع بنفس القدر. فلا هي مُسفه لتخاطب الطبقات الدنيا ، إذا صحت التسمية ، ولا متعالية ، ولا تستطيع من خلالها أن تلجأ إلى التجريب ، الذي هو متاح في المسرح والسينما ، ولكنه خطر جداً في التليفزيون ، الذي يعتمد على التواصل المباشر بين الملقي والمتلقي . وقد يكون العمل فيه عدة مستويات للتلقي . ولكن يجب الاٍقتراب بحذر من موضوعات قد تثير حساسيات داخل الأسر التي تتفرج , ومراعاة التقاليد الرقابية المتعارف عليها". وقام الفنان التليفزيوني بنقل المناسبات والأحداث على الهواء وفوراً إلىٍ المتفرج في غرفته الخاصة ،لأن ظروفه تجعله لا يستطيع أن يتوجه إلى مكان الحدث ، وذلك ليجعله مشاركاً في الأحداث ، يشاهد لحظات الذروة فيها بنفسه ، وليست منقولة إليه عن طريق طرف ثالث . بل أنه حمل كم هائل من المعلومات والمعرفة والأخبار ، والقصص والإعلانات في بيت المتفرج حتى لا يضطر إلى الخروج . وهكذا فرض الفنان نوع جديد من وسائل التسلية والترفيه ، وتمثيليات خاصة به ، وكان يعرف أن الجمهور يجب أن يشترك أفراده ، مع جيرانهم أو حتى في الهاتف ، ولأنه يخاطبهم في منازلهم المتفرقة ، أحس أنهم في حاجة إلى عدوى الضحك الذي قد يسري بين جماهير السينما، فأنشأ فكرة جمع المتفرجين في الاستديو ، أثناء التصوير ، أو عرض نسخة كاملة للتمثيلية الفكاهية بعد انتهائها على جمهور في الاستديو ثم الجمع بين أصوات ضحكهم وأصوات النسخة الأصلية قبل إذاعتها . أو يضيف شريط جاهز مُسجل عليه صوت ضحكات إلى شريط التمثيلية قبل عرضها . عرف الفنان التليفزيوني أن متفرج السينما يولي كل اهتمامه للشاشة وما يحدث عليها بل ومن الصعب عليه أن ينظر أو ينصت أو يفعل أي شيء آخر . بل إنه يجلس على الكرسي نفسه بدون حركة حتى انتهاء الفيلم ، ولذلك فالفنان السينمائي يكتفي باللمحة أو الإيحاء أو الإشارة غير المباشرة دون الحاجة إلى زيادة التصريح والتوكيد في الدراما السينمائية . بعكس جمهور التليفزيون الذي يستطيع أثناء المشاهدة التليفزيونية أن يأكل ويقرأ الجريدة ويرد على جرس التليفون ، ولذلك ابتكر الفنان أسلوبه الخاص ،في السيناريو.ويعبر المخرج التليفزيوني محمد فاضل عن ذلك بقوله : طبيعة الفرجة ، الصالة المظلمة في السينما ، كل المتفرجين جالسين ينظرون ناحية الشاشة , لا يستطيع أحد أن يعلق لأن الشخص الذي بجواره سينهره ، ويمنعه من الكلام ، أي ساعة ونصف تركيز تام بدون أي تشتيت ، هذا بالتأكيد سيفرض تأثير على الفكرة والسيناريو والإخراج والتمثيل ، وكل العناصر الفنية المشتركة ، في المقابل ، أنا أتفرج على التليفزيون وأقوم لأرد على التليفون أو أقوم لأحضر كباية شاي ،أو حد جنبي بيكلمني ، وأجلس وأنا أسند بظهرى على كرسي مريح ، مش قاعد في كرسي السينما مركز ، أو قاعد في السرير باتفرج ، وألبس ملابسي المنزلية وكل شوية ممكن اعدل نفسي ، يعني أنام على جنبي ده شوية ، وأقعد على الجنب ده شوية وأغير طريقة جلوسي ، لكن مش حاقعد قاعدتي اللي في السينما, والتي لا أغيرها لمدة ساعة ونصف,في تركيز كامل .طبعا تغير طريقة الفرجة يؤثر على طبيعة التمثيل وطبيعة الحوار التليفزيوني . في النهاية كان على الفنان التليفزيوني اختيار الفكرة الجيدة ، والقضية التي تهم المجتمع والاعتماد على منطقية الأحداث ، والشكل الفني الجذاب والإيقاع السريع والأحداث المتلاحقة ، التي تجعل المتفرج لا يستطيع أن يتكلم مع أي شخص بجانبه ، أو أن يقوم بفتح الباب أي أن يكون هناك نوع من التواصل الدائم بينه وبين المتفرج . كما أدرك أن البرنامج الناجح هو الذي يعزف على وتر القبول لدى المتفرجين وهو الذي يخاطب متطلبات داخلية في نفوسهم ، وشوقاً لبلورة أفكار وانفعالات ، أو الإطلاع على معلومات . ومن هنا كانت قوة نفاذ هذا الجهاز السحري ، حتى أن "ماكلوهان " الذي قسم وسائل الاتصال في العصر الإلكتروني إلى نوعين : ساخنة وباردة , قال : إن التليفزيون جعل الغريب مألوفاً وجعل الساخن بارداً . بمعنى أن المتفرج مُطالب دائماً بالمشاركة والتفكير والتمعن والإكمال التلقائي للصورة التي يستقبلها لأنها صورة ناقصة باٍعتبارها محدودة في 12، أو 14، أو 19، أو 21، أو 26 بوصة . ويؤكد "ماكلوهان"في كتابه "كيف نفهم وسائل الاتصال " أن وسيلة الاتصال هي الرسالة ، وأن مجرد الجلوس أمام التليفزيون رسالة في حد ذاتها ، بصرف النظر عن المادة . كما لا يمكن إغفال عامل السيطرة التي يفرضها التليفزيون على أوقات الناس مما أوجد جيلاً تليفزيونياً تأقلم بوقته وعاداته مع مواعيد الإرسال التليفزيونية . حتى أن محسن زايد يطلق على هذا الجيل التليفزيوني اسم "الكائن التليفزيوني" أما محمد فاضل فيطلق عليه اسم "حيوان تليفزيوني " . والنتيجة أن التليفزيون عندما دخل ساحة الصراع على جمهور السينما ـالتي كانت تعتبر وسيلة الترفيه الأولى ، والتي زاد الإقبال عليها مع دخول الصوت ، ونجحت في معالجة الروايات والقصص بإمكانيتها الجبارة وكان يطلق عليها أم الفنون لاحتوائها على كل شيء ـ سحب جمهوراً كبيراً من عشاق الجلوس في البيت . وباعتماده على الصورة والتقريب والفورية وإثارة الاهتمام باللون والحركة ،استقطب الملايين من الأميين والكسالى والمكدودين ، في عالم أصبحت متطلباته المادية وعوامل التضخم تشغل الكثيرين عن التعمق وتدفعهم إلى الاكتفاء بما يجود به التليفزيون .كما أنه نجح في أن يحتل عرش الاتصال بعدما أضافت له الأقمار الصناعية إمكانيات هندسية واسعة ، فضلاً عن دخول الكمبيوتر في برمجته وتغطيته لكل شاردة وواردة تهم المتفرج .
الموضوع تم نقله من: http://www.forum.topmaxtech.net/t316.html#ixzz2Mx0KHFpK
المصدر
http://www.arabfilmtvschool.edu.eg/
الموضوع تم نقله من: http://www.forum.topmaxtech.net/t317.html#ixzz2Mwzs5Sqn
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق